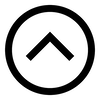ما الذي حملني إلى الهجرة؟ أهلي والأجواء التي كانت تسود في البيت!
فمنذ صغري وأنا أتذكرّ كيف كان أبي وأمّي يصرخان على بعضهما، عليّ ومن ثمّ على أختي الصغيرة. كانا يصّبان غضبهما علينا وكأننا نحن من إختار أن يتزوجا. أضف إلى ذلك، عدم ثقافتهما وجهلهما الذي لم أستطع تقبّله يوماً. فبدأتُ أحلم بالرحيل إلى مكان بعيد، دون أن أعرف إلى أين بالتحديد ووعدتُ نفسي بذلك عندما أكبر. وصبرتُ وتحمّلتُ وإنصبّيتُ على دراستي، لكي يكون لي جميع الفرص لتحقيق حلمي. ولكثرة جهل أبويّ، أرادا أن أتركَ العلم لأتزوج من قريب لنا يشبههم، ولكنني رفضتُ بقوّة لم أتصوّر أنني أملكها، حتى أن خافوا منّي وكفّوا عن محاولة إقناعي. أختي الصغيرة لم تكن محظوظة مثلي، أي أنّها رضخَت لمطالبهم وإنتهَت كزوجة لنفس الرجل الذي كان مخصصاً لي وأنجبَت منه ولداً خلال السنة الأولى لزواجهما ومن بعدها تتالى الأطفال وأصبحَت سجينة عائلة كبيرة ورجل لم تكن تحبّه وبدأَت تصرخ فيهم كما كانت تفعل أمّي. فالمسكينة لم تتعلّم الدرس.
من ناحيتي، كنتُ قد وصلتُ أخيراً إلى الجامعة، المكان الذي يمثّل العلم والحريّة والتقدّم. فكلّما تعلمتَ أشياء زادت معرفتَك بالعالم والناس وتوسّعَ آفاقكَ.
إخترتُ إختصاص علم الأحياء، لكثرة فضولي وحبّي لما يحيط بي وفي نفس الوقت وجدتُ عملاً في مكتبة الكليّة، حيث بدأتُ أقضي كل وقتي أتصفحّ الكتب وأنا أعمل وأقرأ كل ما وقَعَ عليه نظري. وبعد بضعة سنين، تخرّجتُ بدرجة إمتياز دون أن يفرح لي ذويّي، لأنّهم لم يفهموا يوماً حبّي للمعرفة. بنظرهم كنتُ مشروعاً فاشلاً وكانوا يتسألون أين أخطأوا معي. وعندما كان الناس يسألون أمّي عنّي، كانت تجيب والدمعة في عينها: "مريم؟... يا حسرة قلبي عليها... ما زالت عزباء... بالها في علمها... وأنا بالي عليها!"
ما لم تكن تدركُه والدتي، هو أنّ علاماتي في الكليّة، دفعَت مختبر كبير أن يطلبني للعمل لديه وبمعاش مغر جداً. وبالطبع قبلتُ عرضهم وبدأتُ أطبّقُ كل ما تعلّمته طوال هذه السنين. كنتُ أحسُّ أنني في عالم آخر عندما أجلس على كرسيّ وأنظر في المهجر وأحلّل العيّنات، فكانت الحياة بين يديّ وشعوري كان لا يوصف.
ومع مرور الوقت، هدأ الوضع بين والديّ، فلقد أدركا أخيراً أنّهما سجناء بعضهما ولا جدوى من هذا الصراع الدائم وتحوّلا إلى كائنين حزينين ينتظران معجزة تفرحهما أو حدث يغيّر الروتين التي غرقوا به.
وهذا الحدث المنتظر جاء منّي. فنظراً لجهودي ولكثرة إنكبابي على عملي وأدائي الممتاز، قرّر المختبر إرسالي إلى فرنسا حيث مقرّهم. لم أصدّق الخبر! وأخيراً جاءت الفرصة المنتظرة لأهربَ من بيتي وأطيرَ إلى آفاق أخرى تقدّرني وتعتزّ بي!
حزمتُ أمتعتي في ليلة واحدة وإنتظرتُ الإشارة لأنطلق. ودّعتُ أهلي وكأنّهم غرباء وذهبتُ إلى المطار دون أن أنظر ورائي لأنّه لم يكن هناك من شيء أندم عليه أو أشتاق إليه. ذرفَت أمّي شبه دمعة وأبي هزّ برأسه. وأقلعَت طائرتي وإبتسمتُ لمستقبلي.
إستقبلني فريق العمل الفرنسي وكأنني واحدة منهم وبدأنا العمل على إيجاد علاجات للأمراض الخطيرة التي تعاني منها البشريّة وشعرتُ أنني مهمّة ومفيدة. لم أسأل عن أحوال البلد ومَن تركتُ هناك، لأنني لم أرد أن تكون هذه الصلة حبلاً يشدّني إلى الوراء، فلم أعلم بموت أبي إلا متأخّرة. هل حزنتُ؟ ربّما بعض الشيء ولكن ليس كما يجب، فكيف أحزن على إنسان قضى عمره يصرخ علينا ويشتمنا ويعاملنا كسلعةٍ، يتصرّف بها كما يشاء فقط لأنّه رجل؟ علِمتُ أيضاً أنّ أختي أنجبَت ولدها الخامس وأنّ صحّتها تأثرَت كثيراً من كثرة الحمل والولادة والصعوبات الماليّة.
ولم أرَ أمّي وأختي إلا بعد خمس سنوات من رحيلي، عندما أرسلَني المختبر إلى البلد لإلقاء محاضرة بشأن إنجازاتنا في فرنسا. ذهبتُ إلى بيتنا حيث كانت تنتظرني والدتي وشقيقتي. عانقتني أمّي بحرارة وإستغربتُ كثيراً لهذه العاطفة المفاجئة وركضَت أختي إليّ وهمَسَت في أذني: "عملتِ الصواب... أحسدكِ". جلسنا سوياًّ وكنتُ مرتاحة معهنّ. أعتقدُ أنّ أبي كان السبب في التشنجّ السائد في المنزل، فبعد موته هدأت أمّي وأصبحَت لطيفة معي ومع أختي. وقبل ان أرحل مسكتني والدتي بذراعي وقالَت لي:
- أنا فخورة بكِ ولزمَني وقتاً طويلاً لأفهم ما أصبحتِ عليه... أنا إمرأة بسيطة عشتُ مع رجل فظّ يكره الكل وظننت أنّ هكذا هي الحياة. والآن عندما أراكِ، أرى إمرأة جميلة ومستقّلة وسعيدة. لا أدري كيف كانت ستكون حياتي لو فعلتُ مثلكِ... ربّما كنتُ وفّرتُ على نفسي كل الحزن والغضب الذي سكنني سنين طويلة. أرجو أن يكون الله بجانبكِ... وإذا سمحتِ لي بنصيحة واحدة: لا تدَعي عملكِ يلهيكِ عن تأسيس عائلة أو عن إيجاد شخص يشاطركِ حياتكِ.
إبتسمتُ وقلتُ لها بضحكة:
- لا تقلقي عليّ ... هناك شاب معي في المختبر وأظنّ أنّه قد يصبح زوجاً صالحاً...
حاورتها بولا جهشان